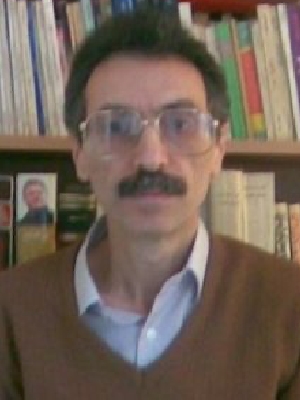صالح الرزوق
اللوحة للسورية جنان داوود
رغم الحياة القصيرة التي عاشها رياض الصالح الحسين (٢٨ سنة)، إلا أنه ترك أثرا عميقا ودائما في مصير وواقع قصيدة النثر. فقد شارك بتحرير الشعر من عقليته ومنطقه الفوقي، وأقحمه في جميع مناحي الحياة. لقد استعمل رياض الميثولوجيا والخيال الشعبي (غير الرخيص – والمتعالي على أدوات واقعه). واختار أن تكون أسطورياته من خارج المنطق الأسطوري المعهود. فقد نظر للموت نظرته للحياة. ولم يكن يوجد عنده فواصل بين الطورين، وبالأخص أن كل شخصياته إما ميتة نفسيا أو أنها حطام وجداني. بتعبير أدق يمكن أن تنسب شخصياته لفكرة الميت الحي. ولكنهم ليسوا على شاكلة أبطال التفكير القوطي، بل جزء من عوالم سائلة تتحكم بها إرادة ضعيفة ومهزومة سلفا، وهي إرادة الإنسان البسيط التي تختزلها بنية المجتمع القهري لجملة أمنيات ورغبات.
التقيت لأول مرة بالمرحوم الشاعر رياض الصالح الحسين في شتاء 1976 في صالون اتحاد الكتاب العرب بحلب، الكائن في منطقة العبارة، قبل أن يتحول إلى شارع بارون، ويحتل المقر السابق لاتحاد العمال، أمام فندق بارون التاريخي، الذي كانت تأوي له أجاثا كريستي، كلما قامت بزيارة شمال سوريا. واستمرت هذه اللقاءات غير المخطط لها على فترات. وكنا خلالها نناقش، بوجود أعضاء الاتحاد الآخرين، بعض المشاكل والقضايا الأدبية، وكان رياض إيجابيا بشكل عام، ويركز معظم كلامه في مسائل الشعر وعلاقته بالتحرر والضمير، ولم يقترب من السياسة حسب علمي، رغم المعركة المحتدمة يومذاك بين القوميين واليساريين (وتزعم التيار القومي خلدون الشمعة والاتجاه اليساري بو علي ياسين). وطوال هذه الفترة لزم الصمت، ولم يكن يتخلى عن أناقته المتقشفة والبسيطة: قميص دون ربطة عنق وبزة رمادية. وكان يطلعني بين حين وحين على آخر قصائده النثرية المكتوبة بخط يده قبل أن ينشرها. وحينما صدر كتابه الأول عن وزارة الثقافة بعنوان «خراب الدورة الدموية» أهداني نسخة للاطلاع، فكتبت عنه عرضا في ثقافية جريدة تشرين. وتزامن ذلك مع صدور كتابي الأول أيضا عن اتحاد الكتاب بدمشق وهو «دفاتر آدم الصغير». وبدوري قدمت له نسخة. وكان لكتابي مقدمة مختصرة ختمتها بالإهداء التالي: “إليكم جميعا وجهي الدميم بمودة”. وحينما لاحظ رياض ذلك، نظر لي بإحراج واضح، وقال: ولكنك لست قبيحا.
طبعا لم أكن أشير لمعالم وجهي، ولكن لوجه الحقبة الكئيبة التي نمر بها جميعا، بكل ما غلفها من أوجاع وخسارات.
لاحقا التقينا عدة مرات في قاعة المؤتمرات في المكتبة الوطنية، وفي قاعة محاضرات المركز الثقافي، وكنا نجلس بكرسيين متجاورين، وأقوم بدور سماعة أو مترجم فوري. كنت أكتب له على ورقة ملخص كل ما يجري أولا بأول. لمن لا يعلم كان رياض أصم وأبكم، لا يسمع أبدا، ولا يتكلم إلا بصعوبة وبطء وبصوت تمثيلي مضحك، وقد تعلم هذه الطريقة بالكلام في مدرسة خاصة بالمعوقين. ومهدت هذه الخدمات التطوعية لتقوية علاقاتي البريئة برياض، وفتحت له الباب لزيارتي في البيت، وحينها كنت أعيش في بيت والدي في منطقة الحريري، والتي أصبحت لاحقا، في أواسط الثمانينات، شارع الاستقلال. وكان الشارع مستقيما، يتصف بالنظافة، ويضم ثلاث دارات وبنائين فقط: مبنى الحريري ومبنى آل السباعي (حيث أسكن مع العائلة). ودارة أو فيلا عواد، وأمامها دارة عبدالكريم، ثم دارة النحاس، وبموازاتها مباشرة بيت الفنان المعروف صباح فخري حين كان في بواكير مشواره مع الفن. وكان يقفل الباب على زوجته قبل أن يذهب للاشتراك بأي حفل فني ساهر. ولكن لم يعد لهذه الذاكرة أي وجود في المرحلة الراهنة. فقد أضاف آل عبدالكريم لدارتهم عدة طوابق لتوطين الأبناء الذين استقلوا بحياتهم. وتحولت دارة عواد لبناء من خمس أو ست طوابق مع مخزن بقال وعيادات طبية وصيدلية. وفقدت البناية خلال الحرب شرفة أحد منازلها، ولا تزال توجد بالواجهة فجوة سريالية مثل الثقوب التي يتعمد الفنان هنري مور تزيين تماثيله بها. وحل مكان بيت الفنان صباح فخري بناء قوطي كئيب الشكل، له شبابيك مستديرة ذات إطار من الآجر الأحمر. وأصبحت نبوءة «الوجه القبيح» التي صدّرت بها كتابي الأول حقيقة. ومهما يكن الأمر كان عنوان هذا الكتاب مقتبسا «أو مستعارا» من إحدى روايات كاتب إسكوتلاندي ذائع الصيت هو ألكسندر تراكي، وهي روايته “آدم الشاب Young Adam“، وتتكلم عن خيانة أخ شاب لأخيه الأكبر منه بالعمر، وممارسة الحب مع زوجته.

«تانغو تحت سقف ضيق» كتاب يضم مختارات من قصائد الشاعر رياض الصالح الحسين (1954-1982) ترجمها إلى الإنكليزية الكاتب والمترجم صالح الرزوق، صدر في الولايات المتحدة الأميركية عن دار «بيتر أولياندير». قام بمراجعة الكتاب وتقديمه الأكاديمي والشاعر الأميركي فيليب تيرمان. وكتب في مقدمته أن رياض الصالح الحسين كان من رواد قصيدة النثر، وتحديداً «قصيدة النثر المحوّرة»، بما أنها مرّت بثلاث مراحل: الأولى مرحلة الريادة في خمسينيات القرن الماضي في سوريا على يد الرائد محمد الماغوط وزوجته سنية صالح، وفي العراق على يد حسين مردان الذي أطلق عليها تسمية «الشعر المنثور». أما المرحلة الثانية، فكانت في السبعينيات من القرن الماضي ومن شعرائها الشاعر أدونيس الذي بدأ بالعمودية ثم التفعيلة قبل أن يكتب قصيدة النثر. والمرحلة الثالثة التي انطلقت فيها القصيدة النثرية المُطَوّرة المتحورة التي لا تزال تحقق انتشارها في العالم العربي، بدأت عملياً في السبعينيات مع رياض الصالح الحسين وبعدها مع نزيه أبو عفش، وتبعهما عادل محمود و منذر مصري وآخرون.
الصعود إلى سطح الماء
لم أكن وقتها أعلم أنني سأسافر لاحقا إلى إنكلترا للتحضير لدرجة الدكتوراه بالتكنولوجيا والبيئة، والتعرف هناك على عدة آنسات إسكوتلانديات. وللأسف لم يرد في ذهني ولو مرة واحدة الإشارة لهذه النقطة، أنني أكتب، وأنني أعرف قصص ألكسندر تراكي، واستعرت منها عنوان أهم كتبه. مع ذلك ربما لم تسمع أي منهن بـ “تراكي”، وربما لن يسرها اسمه، ولا سيما أنه من أكثر أدباء اسكوتلاندا شذوذا وغرابة. فقد هاجر إلى أمريكا، وامتهن كتابة القصص والروايات الخليعة بغرض كسب النقود، ثم عمل وسيطا في بيت دعارة، وتاجر بالممنوعات ومنها مادة الهروين. ولاحقا توفي أكبر أبنائه بالسرطان، وعملت زوجته بالدعارة ثم ماتت بالتهاب الكبد. وأخيرا انتحر أصغر أبنائه.
تكرر لقائي بالمرحوم رياض في مقر مجمع الشبيبة الثقافي بحلب. وهو عبارة عن غرفة للاجتماعات، وصالة لإلقاء المحاضرات. وكانت حينها قد انتشرت عادة كتابة القصص الوثائقية أو التسجيلية التي تمزج الخيال مع الواقع الفعلي. وكتبت بهذا الأسلوب قصة بعنوان «الصعود إلى سطح الماء»، وهي عن مجرم أو ثائر محترف متمرد على القانون، يظهر في ريف حلب في الخمسينات، ويتبادل رؤساء المخافر برقيات عن أخباره مع إدارة الشرطة (أسلوب استعمله عاموس عوز في روايته «الصندوق الأسود» التي ظهرت باللغة الإنكليزية يوم حفل حصولي على الدكتوراة عام 1989 في نوتنغهام – إنكلترا). وقرأ رياض قصتي، ونصحني أن أشارك بها في مسابقة أعلنت عنها جريدة البعث. وكانت تلك هي أول وآخر محاولة لي. كتبت القصة بخط اليد، وأرفقت بها 3 نسخ مطبوعة بالكربون، وأرسلتها إلى دمشق، ونوه بها في عمود خاص محرر الصفحة الثقافية، وكان وقتها بندر عبد الحميد. ولكن حينما صدرت النتائج لم يكن لي فيها أي نصيب. وكان يرأس لجنة التحكيم رياض عصمت، محرر مجلة الشبيبة الناطقة باسم منظمة شبيبة الثورة. وأصبح لاحقا سفير سوريا في باكستان، ثم وزيرا للثقافة، ثم مديرا للمعهد العالي للفنون المسرحية. وختم هذا المشوار بالسفر إلى أمريكا، ليتوفى هناك من جراء الإصابة بكوفيد. وعلى مدى كل هذه المساحة العريضة من تقلد المناصب لم يكن رياض عصمت داعما لي بأي مجال. ومن سخرية الأقدار أنه يشترك مع الصالح الحسين بالاسم الأول.. وهو رياض.
هل كانت هذه إشارة لفكرة سلبية في ذهن المرحوم رياض عن إمكانياتي الأدبية؟.
لا يمكن أن أجزم. هذا احتمال. كنت آنذاك بمطلع شبابي، ويحكمنا التحمس والتهور، أو ما يسمى «أخلاق الأطفال». وبالنسبة لتلك القصة فقد نشرها لي «ملحق العروبة الثقافي» الذي يصدر في حمص، ويرأس تحريره الناقد المعروف فائق المحمد. وللأسف بعد ذلك بأسابيع اغتاله الإخوان المسلمون بعدة طلقات أصابته بالرأس، وتوقف الملحق عن الصدور.
كانت حياتنا محكومة بالارتجال
كان كل شيء في تلك الفترة يتم بمبادرات فردية. وهذه إحدى وجوه الأزمة التي لا نزال نعاني منها، أن حياتنا محكومة بالارتجال وبنوايا واتجاهات الأشخاص. لم أضم تلك القصة إلى كتابي الأول الصادر عام 1980 بعد عودتي من وارسو، ولا إلى كتابي الثاني «مجنون زنوبيا» الصادر عام 1985، وكنت حينها في إنكلترا، أقيم في منطقة غرينستيد من مدينة كولشيستر، مقر جامعة إسيكس.
بعد الدكتوراه وأنا أبحث في أرشيفي وجدت تلك القصة المحزنة. أعدت قراءتها. كان مزاجي قد تبدل. دخان روح الشباب التي تتبخر في الرأس قد خمدت أو انتابها الفتور. ولاحظت أنها بحاجة لتعديلات. ثم رأيت أن الأسهل هو إعادة كتابتها. كانت البلاد تمر بأزمة الحرب الأهلية، ونصف سوريا تحت رحمة المسلحين، وشرق حلب كله بقبضتهم. وهكذا جلست وأعدت كتابة قصة ذلك الشاب المتمرد والخارج على القانون بصيغة مختلفة تماما، واخترت للصيغة المعدلة عنوان «مثل السيف»، وأصبح المتمرد الوحيد فصيلة من المسلحين الذين يحتجزون في ريف حلب حافلة ركاب، ثم يجبرهم الجيش على الفرار. ونشرت لي القصة «جريدة العالم» في بغداد. وأسعدني الحظ في هذه المرة بترجمتها إلى الإنكليزية بمعونة أستاذ الأدب الأمريكي الحديث في أوهايو – لانكستر، وهو الدكتور سكوت ماينار. وتكفل بنشر الترجمة في مجلة أمريكية للناشئين والشباب، ويرعاها مترجمون وشعراء من رومانيا. ولكن يبقى السؤال في الذهن: هل خسارة النسخة الأساسية في المسابقة بقرار من رياض عصمت منفردا أم نتيجة لتوارد خواطر بينه وبين رياض الصالح الحسين؟.
الشك داء لا ينجو منه أحد. لكن ما ينمو لذاكرتي الراهنة أن رياض وقف معي في عدة مناسبات. فقد سهل لي نشر بعض كتاباتي في أهم صحيفة شبابية عربية آنذاك وهي «السفير». وكانت ذات صوت قوي في الحرب اللبنانية، وداعمة للفلسطينيين، وربما هذا هو السبب الحقيقي وراء إفلاسها مؤخرا وسقوطها من الصف الأول إلى نشرة إلكترونية محدودة التوزيع.
كذلك وضعني رياض بصورة دورية أدبية لم تكن عندي أدنى فكرة عن جدية المخاطر المحيطة بها. كانت الدورية مجرد صورة فوتوكوبي من مجلة مطبوعة على الآلة الكاتبة. وقد اقتنيت نسخة منها بسعر ليرة للاطلاع. وقدمت له إحدى قصصي المبكرة المكتوبة لينشرها بمجلته «القاتلة». كانت قصتي بأسلوب حداثي يحاكي مدرسة زكريا تامر.. وحدات قصصية يتخللها مونولوج ومشاهدات لشاب مأزوم يكتشف لاحقا أنه ميت ويعيش في قبر. ولا تخلو تلك القصة، من ناحية موضوعية، من تأثيرات ناتالي ساروت ومارغريت دوراس وروب غرييه. وأعتقد أن رياض قرأها، فقد ناقشني بها، وذكر أنه سيعرضها على هيئة التحرير. لكنه اختفى بعد ذلك، ولم أعرف لا مصير قصتي، ولا مصيره. وضاعت مثل قصة «الخطوط المتعرجة» التي شاركت بها في مهرجان الربيع لاتحاد الكتاب – فرع حلب عام 1978. ثم ألغاه رئيس الفرع لأسباب مجهولة. وضاعت أيضا قصة شاركت بها في مهرجان «جورج سالم وعبدالله عبد معنا» في كلية الآداب بجامعة حلب. وكانت مرثية موجزة لأول أستاذ لي في فن القصة وهو جورج سالم.
وقبل حملة تفتيش قامت بها الشرطة السرية للبحث عن أي أثر للجماعات المسلحة في فترة 1979 – 1980، قام والدي بتنظيف البيت، وطال التنظيف مجلة رياض (لأنها غير رسمية – ومشبوهة أمنيا). ومزق أيضا أول صفحة من كتاب «العقيدة» لعلي الطنطاوي، وكان هدية من المدرسة لتفوقي. اختفت المجلة فيزيائيا، لكن كنت قد قرأتها، وأستطيع أن أتذكر بعض أهم ما ورد فيها: قصيدة للفلسطيني خالد درويش، قصة لجميل حتمل، قصيدة لحسان عزت، ربما مقالة لوائل السواح….
آخر صدفة بيننا
ولم تسنح الفرصة للقاء آخر مع رياض حتى صيف عام 1981 حينما اشتركت بمؤتمر دمشق السينمائي، ورأيته بالصدفة في أروقة فندق دمشق الدولي، وكان يعمل في اللجنة الإعلامية للمهرجان. وبهذه المناسبة استضافني بالبهو، وقدم لي شرابا باردا، ونشر إحدى صوري بمجلة «الحياة السينمائية» مع مخرج كوبي وبرفقة عدة وجوه من شباب جامعة حلب. ولم أكن أعلم أنها آخر صدفة بيننا. لكن تابعت الاطلاع على قصائده، واقتنيت مجموعته الثانية فور صدورها وهي «أساطير يومية». كان أمامي على الطاولة عمود من الإصدارات الحديثة، وكانت ذات أثر بالغ بتكوين شخصيتي في منعطف هام ومبكر من حياتي، ومن أهمها «المصائر التاريخية للواقعية» لبوريس سوتشكوف، و«المعجم الصوفي» للدكتورة سعاد الحكيم، و«ضياع في سوهو» لكولن ولسون، وعدة مجلدات للمصري غالي شكري، وهي كالعادة فضائحية وتهاجم ولا تلوم أو تنتقد فقط. وضعتها جانبا وباشرت مع «أساطير» رياض، ورأيت أنها سريعة الإيقاع، وأبعد ما تكون عن النثر، مع أنها شعر نثري وسردي. فلوحاته الغريبة تخاطب أعمق تصوراتنا عن واقع حسود وغيور، يضن علينا بكل أشكال السعادة، ويكرم بسخاء في توزيع المآسي والأحزان. وكان رياض يعزف على هذا الوتر بمهارة فائقة، فهو لا يركّب الصور من بنات خياله، ولكن بإعادة ترتيب أحلامنا الممنوعة. ولذلك كانت قصائده عبارة عن بيوت زجاجية مهشمة، أنقاض حطامها هو تصوير موضوعي لوضعنا البشري. لقد كنا نعيش في مدينة كتب عنها زامياتين ملحمته الخالدة «نحن». وكانت السلطات تحكمنا بطريقة عالم صوره أورويل في روايته الشهيرة «1984». وكنا نقضي نحبنا دون شفقة بين البيوت الزجاجية التي تعري الإنسان من كل خصوصياته حتى تتحول حياته لفضيحة، وبين قبضة الأخ الأكبر الذي يعد على أنصاره وقواعده أنفاسهم.
ولكن لدى القدر فواجع بقدر ما لديه من مفاجآت سعيدة!!.
في عام 1984 سافرت إلى إنكلترا لمتابعة تعليمي العالي، وودعت الأصدقاء في حلب ودمشق، ولم يكن بينهم رياض. والحقيقة أنني نسيت أن أسأل عنه، واعتقدت أنه مشغول بغرامياته التي لا تنتهي. كان رياض محظوظا من هذه الناحية، لكنه لا يتباهى بذلك على طريقة نزار قباني، ودائما يعرض صورته على أنه شاب خانته الحياة ورفضته السعادة من بيتها. ولم يحاول أن يتباهى ولو بقصيدة واحدة بفحولته على طريقة شاعر النكسة نزار. كان نزار شامتا في أغلب الأحيان، ويهاجم المشهد العربي بطريقة ماتادور مهتاج، ولم يبق إلا أن يفتخر باغتصاب الجميلات أو بقطع رقاب الحسناوات مثل شهريار. كانت لدى نزار عقدة رياض. غير أن رياض كان يأكل عقدته، ويشبّه المرأة بالبحر والنبع والقنبلة والبرتقالة، وكان يقشرها ويحاول أن يقضمها بأسنانه. في حين أن نزار كان يبالغ بتعويم عقدته، ويلح على المساكنة والمضاجعة.
لم أبتعد في كولشيستر عن جو رياض، وإن غاب هو شخصيا عن ذاكرتي. وشاءت الظروف أن أشهد في جامعة إسيكس نشاطا لإدوارد سعيد، وربما هو أفضل من تعامل مع النقد الأدبي والثقافي بروح شاعر مدفون بين شتى المراجع الليبرالية والغربية. وأيضا شهدت نشاطا استثنائيا شارك به بيير ماشري وفوكو ودريدا، وهم أعمدة الثقافة الفرنسية المتحررة من الإملاءات.
الموت لا ينتقي ضحاياه
وفي صيف عام 1985 قمت بأول زيارة إلى دمشق. شاركت بمؤتمر اتحاد الكتاب العرب، وتابعت إلى حلب، وهناك استفسرت عن رياض، لأنني افتقدته في أروقة الاتحاد. ومن عادته أن لا يوفر أي نشاط ثقافي وطني، إن لم يكن بغرض إثبات الوجود، على الأقل لتغطيته إعلاميا. وجاء الجواب المفجع: أنني تأخرت بهذا السؤال. فقد مرض رياض عام 1982، وتوفي بعد فترة بسيطة. وتبعه بفارق زمني بسيط محمد أبو صلاح. ومات مثله بسكتة قلبية. كان أبو صلاح فنانا تشكيليا فلسطينيا، وقد أهداني نسخة من لوحاته في النادي الفلسطيني في شارع إسكندرون بحلب، وكان موضوع اللوحات المقاومة والصمود.
لسنا بصدد مناقشة أدوات التعبير الفني، التي حكمت نشاطنا في السبعينات والثمانينات، ولا مناقشة أطروحة تلك الفترة، ولكن ما لا يمكن التغاضي عنه أن القدر جمعنا نحن الثلاثة عام 1981 باجتماع هيئة اتحاد الكتاب العرب بدمشق. فقد دخلت لقاعة الاجتماعات برفقة رياض، وكان خلفنا محمد أبو صلاح، وطلب منه الحارس هوية إثبات شخصية، فأبرز له بطاقة اتحاد الصحفيين الفلسطينيين. جلست أنا ورياض على طاولة واحدة. وأمامنا خيري الذهبي (ولم يكن له آنذاك غير كتابين صدرا عن اتحاد الكتاب وهما «ملكوت البسطاء» و«طائر الأيام العجيبة»)، وبرفقته مستشار في رئاسة مجلس الوزراء، وهو المترجم المعروف عدنان بغجاتي. وكان عراب المؤتمر أدونيس الذي لم يقبل بدخول القاعة، واكتفى بالوقوف في الممر ومراقبة الشارع من النوافذ. وضاع منا أبو صلاح وسط بقية المشاركين وهم حوالي 200 عضو.
الموت لا ينتقي ضحاياه إن كنا منطقيين، والحياة لا تحتفظ بأحد لنفسها. ومثلما للغياب قوانينه، للتغييب قوانينه أيضا. أستطيع أن أقول إن غياب محمد ورياض لا يعني إلغاء الأثر المتبقي من كليهما. فقد صدرت أعمال فلسطينية عن جدوى فن محمد أبو صلاح، ومنها مجموعة شعرية بعنوان «محمد أبو صلاح يطير عصافير المخيم» لمحمود السعيد، وهو شاعر فلسطيني، أصدر لبعض الوقت مجلة أدبية بعنوان «المقاومة»، ثم أعاد برمجتها وأصدرها من لندن بعنوان «النافذة». ولم يكلفني بالمشاركة في تحريرها بالمرتين، رغم قربي منه.
بالمثل لم تتوقف دورة شعر رياض الصالح الحسين عن الدوران، حتى أنني عملت على ترجمة مختارات من شعره للإنكليزية بالاشتراك مع فيليب تيرمان أستاذ الأدب الحديث في جامعة كلاريون. ومن أغرب المصادفات أنه يهودي أمريكي يحن لفسلطين بمقدار ما يجد ضرورة لإسرائيل. وإن كانت ميوله لفلسطين عاطفية وفانتازية فتصوره لإسرائيل نابع من محنة اليهودي في وجوده. وهو يعتقد أن اليهود لا يريدون فلسطين بالذات، ولكن أي فرصة ليتخلصوا من الاضطهاد التاريخي والملاحقة والقتل (بالإشارة للمحرقة). وقد نشرت ترجمتنا دار بتر أولياندر The Bitter Oleander press في صيف عام 2021 بعنوان «رقصة تانغو تحت سقف ضيق Tango Below Narrow Ceiling»، يعني بعد وفاة رياض بما لا يقل عن 40 عاما. ومع ذلك يبقى أن الكتاب لرياض، ومرتبط باسمه، أكثر من اسم مترجمه، وهذه محنة لا تقل عن تجربة الموت، أن ترى أنك تدين بوجودك لظل رجل ميت.
الحصيلة النهائية لمعراج رياض
السؤال الآن: ما هي الحصيلة النهائية لمعراج رياض في حياته ومماته؟.
إذا تركنا الجانب الاجتماعي، ولم نربط النص بالسيرة الشخصية للشاعر، ولا بشبكة علاقاته فوق الأدبية، أقصد كل ما لا يدخل في وعيه الفني، نستطيع أن نجد له أثرا عميقا ودائما في مصير وواقع القصيدة النثرية. فقد شارك بتحرير الشعر من عقليته ومنطقه الفوقي، وأقحمه في جميع مناحي الحياة. لقد استعمل رياض الميثولوجيا والخيال الشعبي (غير الرخيص – والمتعالي على أدوات واقعه). ولم يفعل مثل أدونيس الذي اعتمد على البنية التموزية بالإيقاع والموضوع. فهو لم يستعمل شكل القصيدة المستديرة، التي تبدأ وتنتهي بفكرة مكررة، وهي ضرورة الحياة وتحدي الموت. واختار أن تكون أسطورياته من خارج المنطق الأسطوري المعهود. فقد نظر للموت نظرته للحياة. ولم يكن يوجد عنده فواصل بين الطورين، وبالأخص أن كل شخصياته إما ميتة نفسيا أو أنها حطام وجداني. بتعبير أدق يمكن أن تنسب شخصياته لفكرة الميت الحي. ولكنهم ليسوا على شاكلة أبطال التفكير القوطي، ولكنهم جزء من عوالم سائلة تتحكم بها إرادة ضعيفة ومهزومة سلفا، وهي إرادة الإنسان البسيط التي تختزلها بنية المجتمع القهري لجملة أمنيات ورغبات. وهذه هي عناوين قصائد كتابه «أساطير يومية».
إن كنت لا أعرف نفسي هنا كيف سأبحث عن بقايا رياض؟
طلب مني تيرمان ما بحوزتي من أوراق بخط رياض، لكن لم أجدها في أي مكان، ضاعت من مصنفاتي وأضابيري، ومن رفوف المكتبات الموزعة في كل أرجاء المنزل بين غرفة المعيشة وغرفة الزوار وحتى غرفة النوم. ولم يكن من الممكن أن أعرف في أي محطة فقدتها. لكن قبل أن أستسلم لهذه النتيجة قررت أن أبحث عنها في بيت الوالدة.
وأستعمل حاليا هذا التعبير لأن الوالد رحل بظروف مأساوية في عام 2007، نتيجة مضاعفات الإصابة بسرطان المثانة، وجرعة إشعاع زائدة. لكن عمليا كان البيت بالقانون للوالدة منذ عام 1966 بعد انقلاب صلاح جديد اليساري واعتقال الوالد بوشاية ملفقة. ونجم عن ذلك إصابته بكراهية عميقة لليسار والاتجاه للتدين والانقطاع بعزلة تامة عن المجتمع. وفي أعقاب إطلاق سراحه المشروط تنازل عن كل شيء للوالدة حتى يضمن عدم مصادرة السلطات لها والعودة للتنكيل. غير أن هذا لم يمنع رياض الراديكالي واليساري أن يرتاح للوالد. وأخبرني بعدة مناسبات أنه إنسان وسيم الهيئة لشخص بعمره وتفكيره.
بالمناسبة لرياض ولع بدراسة الصور والوجوه. حتى أنه استعار مني روايتين هما «صورة الفنان في شبابه» لجويس و«صورة دوريان غراي» لوايلد. حكاية طالب معهد ديني وتفاصيل سيرة شرير تعاقد مع الشيطان. كأنه كان يفكر بعقلية روبرت ستيفنسون مؤلف «الدكتور جيكل ومستر هايد». وربما هذا يعكس طبيعة التناقض الذي يبني عليه حياته، وهو القناعة بظروف الواقع وما وراءها من رغبات تدميرية.
بمجرد أن دخلت البيت غمرني هدوء يشبه هدأة المقابر في ليالي الصيف فشعرت بالعجز فورا. كيف أبحث عن رزمة من أوراق في بيت تبدلت كل ملامحه، وخيم على جنباته العجز والفراغ. فقد كانت النوافذ مغلقة ولا يتسلل منها ولو خيط واحد من الضوء. وكانت خدمة الكهرباء الحكومية مقطوعة بسبب الحرب. ولم يئن أوان خدمة المولد المحلي. وكانت تشكو منه الوالدة. فهو يضيء لها طريقها، غير أنه يصم أذنيها ويفتك بصفاء ذهنها، صوته لا يقل عن صوت الدبابة الروسية التي تذرع شارع بيت طفولتي البريئة.
وطبعا لم أجد شيئا. كنت أطارد أشياء غير موجودة. لم يعد البيت بيتنا (أقصد أنا ورياض وأحلام ذلك الجيل بكل مشاربه). ولم تعد المرحلة تعبر عن رغباتنا العميقة. ماتت الصور التي يمكن أن نقاتل ونصمد من أجلها، وحلت محلها أطياف تسبب لي الشيزوفرانيا، أريد أن أهجوها وأخجل، وتتحول لصوت مدمر يمزقني من الداخل، يذبحني بسكاكين لا تراها العين، مثلما يفعل صوت مضخة المياه ومولدة الكهرباء أو القذائف التي يتبادلها الجيش مع المسلحين، والفلول المتبقية منهم في ضاحية الأغنياء في محيط المدينة.
حاولت أن أبدأ بالبحث من الغرفة التي اعتدت أن أستقبل بها رياض، ورأيت أنها تحولت لغرفة نوم لأخي الأصغر.
وقد اختفت خزانة أوراقي، وحل محلها خزانة، مقطبة الملامح، من لون واحد. اختفت أيضا الكراسي والطاولات. و لم أشاهد غير سرير مفرد بنوابض معدنية، وقد تكومت فوقه الأغطية.
إن كنت لا أعرف نفسي هنا كيف سأبحث عن بقايا رياض؟!.
وكتبت هذه العبارة لفيليب تيرمان الذي أشرف على مشروع الترجمة. واتفقنا أن نضيف للكتاب صورة رياض بالأبيض والأسود، وكنا قد وجدناها بالإنترنت. ولم يبق أمامي الآن غير أن أعترف أنني إنسان بنصف ذاكرة، أعيش بعالم افتراضي مثل محاضرات الزوم وأفلام اليوتيوب. لا يوجد مكان أنتمي له، وإنما أسبح في هذا الفضاء الكوني حول فكرة وهمية مثلما تسبح الكواكب كلها في الفراغ اللامتناهي…..

رياض الصالح الحسين شاعر سوري مواليد ١٩٥٤، منعه الصم والبكم من إكمال دراسته، فدأب على تثقيف نفسه بنفسه. اضطر إلى ممارسة العمل مبكرًا كعامل وموظف وصحفي. أصدر أربع مجموعات شعريّة ثلاث منها في حياته: «خراب الدورة الدمويّة» 1979، «أساطير يوميّة» 1980، «بسيط كالماء واضح كطلقة مسدَّس» 1982، والرابعة «وعل في الغابة» صدرت بعد وفاته.. توفي في مستشفى المواساة بدمشق العام 1982 لأسباب غامضة.
صالح الرزوق، كاتب وناقد ومترجم سوري، مواليد عام ١٩٥٩، درس في جامعة حلب وفي بولندا وعدة جامعات بريطانية. له مجموعة من المؤلفات الأدبية، منها «المأساة في الأدب»، «فوكو والجنسانية»، «الحركة الرومنسية في القصة السورية»، «موت الرواية – أزمة الخيال الفني بعد عام ١٩٨٥»، «تحرير الحداثة: الرواية المضادة في أعمال سعد محمد رحيم»، بالإضافة إلى ترجمات في الصناعة والتكنولوجيا.